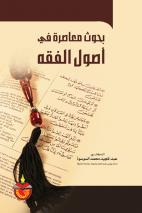
بحوث معاصرة في اصول الفقه
إنَّ أصول الفقه هو المنهجية التي تضبط للدارسين فهم أصول الشريعة واستنباط الأحكام منها، وتبعدهم عن التخبط واتباع الأهواء، وقد جاء هذا العلم مبثوثاً في الشريعة الإسلامية منذ أنزلها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فأخذه الصحابة من الرسول وتعلمه التابعون من الصحابة، وورثه عنهم تابعوا التابعين، ثم صار علماً مستقلاً بعد تدوينه وبروزه في كتب مستقلةٍ شأنه في ذلك شأن الكثير من العلوم الإسلامية التي بدأ تعلمها وتناقلها شفاهةً ثم تطورت ودونت وصارت علوماً مستقلةً.
وقد بدأ تدوين هذا العلم – كما هو مشهور – على يد الإمام الشافعي رحمه الله فهو أول من ألف كتاباً مستقلاً في علم أصول الفقه ثم تتابعت جهود العلماء متخذةً من أسلوب الشافعي طريقةً ساروا عليها في تأليفهم لكتب الأصول، واختط بعض العلماء أسلوباً آخر في التأليف أطلق عليه طريقة الحنفية، وجاء بعد الفريقين علماء آخرون عملوا على الجمع بين الطريقتين فألفوا كتباً تجمع بين طريقة الشافعية وطريقة الحنفية. وبعد ذلك ظل التأليف في علم الأصول يسير في إطار ما كتبه السابقون إلاَّ أنه شاب هذه المؤلفات التعقيد في الصياغة، وإضافة مباحث غريبة لا يترتب عليها أثر في الفقه الإسلامي مما حدى ببعض العلماء إلى بذل جهودٍ في تنقيح علم أصول الفقه وتهذيبه مما ليس له صلة حقيقية بهذا العلم.
وعمل كثير من العلماء المعاصرين على التأليف بأسلوب يتسم بتيسير هذا العلم وربط قواعده بالآثار الفقهية وإظهار الأثر الكبير للتشريع الإسلامي في معالجته للوقائع القائمة والمستجدة.
وفي إطار ما سار عليه العلماء المعاصرون، واستناداً إلى الثروة الأصولية التي كتبها العلماء المتقدمون حاولت المساهمة بالكتابة في عددٍ من الموضوعات الأصولية التي أرى أن الكتابة فيها وتقديمها للدارسين في هذا العصر يساعدهم على ما قد يواجهونه من إشكالات في فهم منهجية الشريعة وأصولها بشكل صحيح.
وجعلت هذه الموضوعات في بحوث ستة مرتبة على النحو الآتي:
البحث الأول: تجديد أصـول الفقـه (تاريخه ومعالمه): وقد تناول مراحل التأليف في علم أصول الفقه ومعالم التجديد المنشود لهذا العلم؛ حيث أبان المراحل التاريخية التي مرَّ بها هذا العلم نشأةً وتدويناً وتطوراً واكتمالاً ونضجاً وتقليداً ثم إحياءً وتجديداً كما وضح الاتجاهات المختلفة الداعية إلى تجديد أصول الفقه، وانتهى إلى تحديد المعالم التي ينبغي أن يتم التجديد في إطارها ليكون سليماً منضبطاً.
البحث الثاني: ضوابط الفتوى في القضايا المعاصرة: وقد تناول ما يجب أن يتوفر في المفتي من مؤهلات وصفات تمكنه من الفهم الدقيق للأحكام الشرعية، وفهم طبيعة القضايا التي يفتي فيها وملابساتها، وما يجب أن تتصف بها الفتوى من دقةٍ وتيسير ومراعاة لمصالح الناس وعلوم العصر ومستجداته والتزامٍ بالجماعية والشورى في الفتوى لتكون بذلك أكثر دقةً وإصابة ودافعة إلى جمع الآراء وتوحيد الأمة.
البحث الثالث: الثبات والتغير في الحكم الشرعي: وقد أظهر أن الثبات هو الأصل وأنَّ التغير هو الاستثناء الذي يحدث للأحكام المبنية على عللٍ أو مصالح متغيرة، كما أبان هذا البحث الضوابط الشرعية لتغير الأحكام ليسد الباب على من يريدون التفلت والتحلل من أحكام الشريعة بدعوى تغير الأحكام.
البحث الرابع: ضوابط التأويل: وقد تناول الضوابط اللازمة للتأويل الصحيح التي يجب الأخذ بها خصوصاً في هذا العصر الذي جهل فيه كثير من الناس تلك الضوابط فوقع الزلل في التأويل أو الجمود في الفهم والتفسير. وفي هذا البحث توضيح لأهمية التأويل باعتباره من أخطر الموضوعات وأشدها حساسية على مدار القرون العديدة في مسيرة الفكر الإسلامي وبيان نصوصه ومفاهيمه.
البحث الخامس: السياق وأثره في دلالات الألفاظ: وقد تناول مفهوم السياق ومعالمه وأنواعه وأثره في دلالات الألفاظ وأوضح دور السياق في فهم النصوص وضبط معانيها. وأظهر أهمية السياق في كونه من أفضل المناهج لدراسة دلالات الألفاظ ومعاني النصوص، وأبان دور علماء الإسلام منذ القدم في وضع المعالم الأولى والأسس الضرورية لدراسة السياق بما يؤكد سبقهم للدراسات اللغوية الحديثة في تنظيرها للسياق ودوره.
البحث السادس: التخصيص بالعرف وأثره في الفقه الإسلامي: تناول تخصيص العرف للنصوص العامة حيث أظهر دور العرف في بيان النصوص وتحديد دلالاتها وتخصيص النص الشرعي بالعرف اللغوي المعهود في لسان العرب عند نزول الوحي، كما ناقش هذا البحث دور العرف العملي والعرف الطارئ في التخصيص، وأتبع ذلك بأثر تخصيص العام بالعرف في الفقه الإسلامي.
تلك هي الموضوعات التي تناولها هذا الكتاب لتكون بين يدي الدارسين للاستفادة منها لما لها من أهمية بالغة في فهم منهجية التشريع الإسلامي.